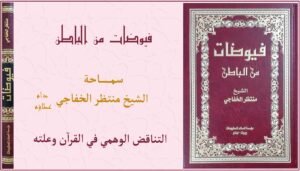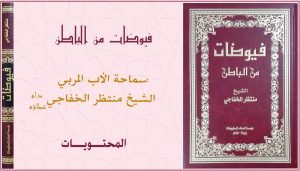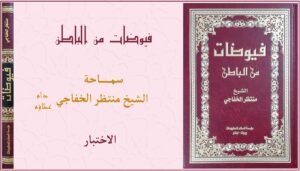الباب العشرون
الحــــــــــال
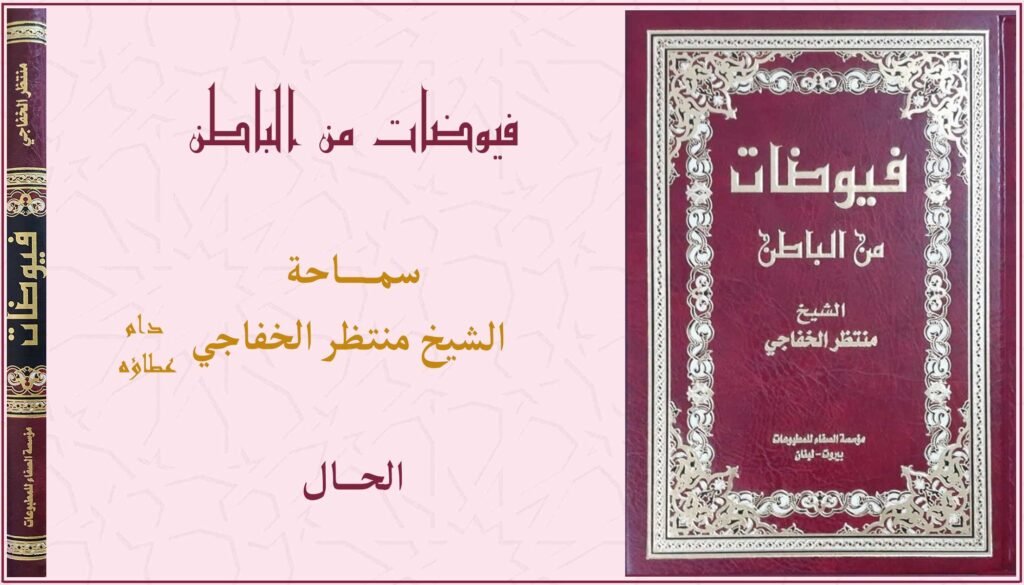
الحال هو تغير يطرأ على الموجود فيُحوّله من الوضع الذي هو فيه إلى وضع آخر، فيَحول دون استقرار الموجود. وهو من ركائز النظام الإلهي بقسميه المادي والمعنوي. ولكل عالم أحواله التي تكون من سنخه.
ففي الظاهر، تطرأ على أهل الدنيا أحوال عديدة، ومنها حال الجوع والشبع، والصعود والنزول وما شابهها من الماديات والمعنويات.
ووجود هذه الأحوال هي من أكبر الأسباب لبقاء الاتزان في النظام الظاهري، حيث تسيير النظام الظاهري يكون بما يطرأ من التغيرات على من هو في داخل إطار هذا النظام، أما مع عدم وجود الأحوال، فسيؤدي إلى الاستقرار الظاهري وسقوط السببية فيه، وهي تعود إلى أصل معنوي يكون ظل قيامه في الماديات، فتكون الأحوال الظاهرية في الأشياء الجسمانية والتي تعكس تأثيرها على النفس لا دائماً، إنما الانعكاس يكون عبر الترابط المادي المعنوي، أما إذا انقطع ذلك الرباط فيكون حالاً مادياً خالصاً عند النظر بالعين اليسرى. ولكن الغالبية الكبرى في وجود رابطة بين الاثنين، إذ أن القطع يكون معنوياً مصطنعاً، أي يقطع الرابطة بين المادة وما ترتبط به منه لا منها، وإلا فمن المحال تحقق الثانية للحكمة التي ذكرناها.
أما الأحوال في الآخرة فهي في تفاوت على حسب مراتب الآخرة، فإن أصحاب النعيم الجسماني يكونون في أحوال ذات تأثير تصاعدي متوسط لكونها أحوالاً داخل الملذات، وبما أن النعيم الجسماني متوقف، فسوف يقتصر أصحاب هذا النعيم على نِعم محدودة، حينئذٍ الأحوال قليلة.
وهذه الأحوال في جانب واحد من جهة الملذات الجسمانية والنفسية ولا يتعدى إلى الجانب الآخر. وحتى إن تقدمنا وقلنا بالدخول في الجانب الآخر من منطلق الانغماس باللذة يولد الألم، فسيكون هذا الدخول بقدر معلوم حيث أن من عرف الفضيلة عرف الرذيلة بالإلهام بما أن الحق ألهمها فجورها وتقواها.
أما أصحاب الجحيم المادي، فهم كذلك في أحوال مستمرة وأحوالهم تصاعدية. ومن هذا التصاعد تفتح أبواب جهنم، فإن العذاب الواحد دون الأحوال يولد الاعتياد الذي يمحو بدوره صورة العذاب، فمن فَعلَ فعلاً نفسياً واستمر عليه أستساغ هذا الفعل، ثم أحبه، ثم اعتاد عليه، ثم فُني به، فإن وصل إلى تلك الدرجة صعب الإقلاع عنه، وهذا ظاهر في الحياة الدنيا ولا يحتاج إلى بيـان، حتى يدخل ذلك الفعل في أكثر الأشياء؛ لذلك لزم تغير الحال عند أصحاب الجحيم أكثر من أصحاب النعيم لكيلا يعتادوا على العذاب فيتوقفوا.
الجانب الآخر إن قوة الاعتياد تعتمد على الفعل، فإن كان صعب الفعلية عَظُم التمسك به والاعتياد عليه وصعُب الإقلاع عنه، فمن كان أصله صعبٌ، صعب الإقلاع عنه بعد التعود، وهذه طبيعة نفسية، ومن كان في الظلام رفض النور، ومن كان في النور رفض الظلام.
وكما قال تعالى: ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ |البقرة: 6| إنما طُبع ذلك الفعل في ألواح قلوبهم، فإنهم بعد وصولهم إلى مرحلة معتدٍ بها من التعمق في الفعل الموجبة للتسلسل الكمالي فيه، صَعُب عندئذٍ الإقلاع عنه. وهذا كله يصب في صالح النظام العام حيث يستمر النظام في مسيره.
أما الأحوال في الباطن: فالحال في الباطن هو تحوّل واستعداد وإتمام، حيث تَمُر على طالب الكمال أثناء مسيره أحوال عديدة، ومن تلك الأحوال، الحال الأولي الذي يكون في أول دخول المقام -أي مقام كان- ومنها بعض الأحوال التي تكون كمال لذلك المقام عند تجاوزه. وهناك أحوال كماليةٌ تتنزَل على المريد من اجل إتمام نقص في المقام الذي هو فيه، وغير ذلك.
وهذه الأحوال تكون في تفاوت بالنسبة لزوالها، فمن الأحوال ما يكون كالبرق، ومنها ما يمكث مدة طويلة. ومن هذه الأحوال، حال التسليم عند من شارف على إتمام مقام التوكل، فسوف ينزل عليه حال من التسليم مقدمة لمقام التسليم، وكحال الفناء قبل الوصول وغيرها من الأحوال.
وهنالك من الأحوال ما تكون تبشيراً لدخول مقامها، فعندما ينزل نازل الحال في السَفر الأول فهو رسول المقام الذي سيدخله المريد، وبعضٌ منها ما يكون نوعاً من أنواع الإعداد للمقام الذي جاء منه الحال. والحق يكشف للمريد في الباطن المقامات التي سيدخلها بنزول الحال.
ومن بعض خصائص الحال أن يكون تعميق واستقرار للمقام الكائن به المريد، وتوضيح ذلك: من كان مثلاً في مقام المحبة، يُنَزّل عليه حال العشق فعندها تستقر المحبة في قلبه، والاستقرار هو كمال المقام، عندها يصبح حال العشق مقاماً، ويستقر العشق بنزول حال المشاهدة، أي أن نزول الحال هو استقرار للمقام الأول ودخول لمقام ذلك الحال، فيكون دخول مقام المشاهدة ثم ينزل حال الفناء وهكذا.
ويأتي الحال مبكراً أحياناً، وأحيانا يتأخر حسب استعداد المريد.
ولكلٍ من النفس والقلب والعقل أحوال تختلف على حسب طبيعة العالَم.
فأما الأحوال النفسية، فإن طبيعة التكامل النفسي يقتضي وجود أحوال نفسية، أي نازلة إلى النفس تؤدي إلى عدم استقرار النفس، فالصفات النفسية فيها ما يَحتجب بالظواهر كالعبادات أو غيرها فهذه الصفات لا تعرف إلا بالتقلبات والأحوال التي تصُب في صالح الكمال المرتبي، وهي باب من أبواب الكشف الذهني، أعني أنه يكشف للإنسان ذهناً النواقص الصفاتية التي لا يبصرها إلا من خلال هذه الأحوال، فإن الحال هو المثير للرذائل والمظهر لها، فتكون هذه الأحوال مقياساً للنفس ومعرفة صفاتها.
أما بالنسبة للقلب، فإن له أحوال كثيرة وقد تفوق أحوال النفس، وهي من كمالات القلب ومن عمله، ومن هذه الأحوال الكُربة والانشراح، والسكون القلبي، والحزن والفرح وغيرها، وهذه الأحوال تكون السبب الأكبر لمعرفة القلب والتعامل معه ثم تجاوز مقام القلب… وكذلك تحول الأحوال القلبية دون توسع القلب.
أما العقل، فإن الدخول إلى مقام التفكر يولد الأحوال العقلية من بداية المقام، ومن هذه الأحول التنقل الذهني، حيث ينتقل فكر المريد من الفكرة المراد العمل بها إلى فكرة أخرى، وتنتهي هذه الأحوال -أعني تأثيرها- عند التوغل في عالم الجبروت والاتصال بالعقل الفعّال، بحيث يكون هناك سيطرة على العقل، وللمريد قابلية السيطرة على الأحوال العقلية.
الأحوال الحقيقية هي فيض من الحق إذ أنها مستفادة من صفته الباطنية تعالى والبائنة في قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ |الرحمان: 29| إذ تجلي الشأنية الحقيّة في الخلق لا في الحق بما أن الخلق مرآة للحق.
والأحوال عطاء من الحق فمن نزل عليه حال لمقام ما، فليعلم بقرب ذلك المقام، وتكون سبب في تكامله.
وربما رأى الإنسان بعض الأحوال أنها صادرة من النفس وليس من جهة عليا لأنها تحمل الصفات النفسية وتخلو من النفحات الإلهية، قلنا إن هاهنا وجهين:
الوجه الأول: إن الأحوال تارة تكون صادرة من جهة الإنسان، وتارة نازلة إليها، فما شابهت صفات الجهة نسبت إليها بلا إشكال.
الوجه الثاني: إن الحال إذا فُصِل بالاستقلالية الظاهرية فمن النفس. أما في الباطن فإنه من الحق. وأما في الواقع فهو من الإنسان، سواء أكان حالا نفسيا أو قلبيا أو عقليا -ولا تنافٍ بين الثلاث- ولا يُميَز إلا بالذوق والكشف الحقيقي.
ولو تقدمنا خطوة في معرفة الحال، لوجدنا أن للحال مقدمات وهي التي يتميز بها الحال الإلهي عن الأحوال الإنسانية في مراتب الفصل، ومن هذه المقدمات الخواطر، وإن كان منها ما لا يكون مقدمة للحال. والأحوال كلها لا تُعرف إلا عند المعايشة.
وهنالك شيء آخر، وهو إن الحال يتكرر أحيانا في أمر واحد، ومثال ذلك، أن ينّزل الحق على المريد حال التوسيع
فينبعث من باطنه داعيته، ثم تزول هذه الداعية بطغيان صفات النفس، عندها يُنزل الحق حالاً آخر للتوسيع من اجل تقوية الداعية حتى يصل الإنسان إلى السيطرة، فيكون ذلك
الحال مقامه المطلوب.
ومن المشاكل التي تواجه طالب الكمال هو عدم التمييز بين الحال والمقـام، وربما أدى عدم التمييز هذا إلى عدم دخول بعض المقامات، لظن المريد الحال مقاماً فتنصرف إرادته عن دخول المقام، ثم تسقط الإرادة لذلك المقام، ومن ثم يُحجب عنه. فمن أبرز الفروقات بين الحال والمقام هي:
أولاً: إن الحال يُعدُ من النوازل، أي ليس للإنسان أن يصل إليه، أما المقام فإن الإنسان هو الذي يدخله.
ثانياً: إن الحال إجمالا لا يدوم فترة طويلة، إنما يكون نزوله لحظات، أما المقام فإن المريد يقيم فيه فترة طويلة.
ثالثاً: في المقام يظهر الكمال ويبطن العطاء، أما في الحال فيظهر العطاء ويبطن الكمال.
رابعاً: إن المقام يعتمد على الحال وليس الحال كذلك. والتوكل على الحق تعالى يغني عن كل سبيل.
أما فوائد الحال فإن له فوائد لا تحصى، حيث لكل حال فوائد تختلف عن غيره من الأحوال، لكن من الفوائد المشتركة:
أولاً: إن الحال هو استعداد لدخول المقـام، أي أن المريد يُحجـب عـن دخول أغلب المقامات دون الحال لذلك، فالحال يوجب تحـّول نفسي لذلك المقام، وان كانت هناك إرادة باطنية، ولكن الإرادة الباطنية إجمالية لدخـول المقام.
ثانياً: إن بعض الأحوال تكون ذات فوائد بعيدة، فمنها ما يكون فائدته في السفر الثالث أو الرابع لمن هو في السفر الأول.
ثالثاً: تُعطي بعض الأحوال التوسعات في الكمالات الجزئية.
رابعاً: يعطي اسـتعداداً للوصـول إلى حقيقـة المعايشـة لكـل المعـارف الكامنة في السفر الثاني. هذا إضافة إلى الفوائد التي ذكرناها سابقا. ونكتفي بهذا المقدار بخصوص الحال.
(والحمد لله الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً)