الشذرة الثالثة من الصحيفة السجادية
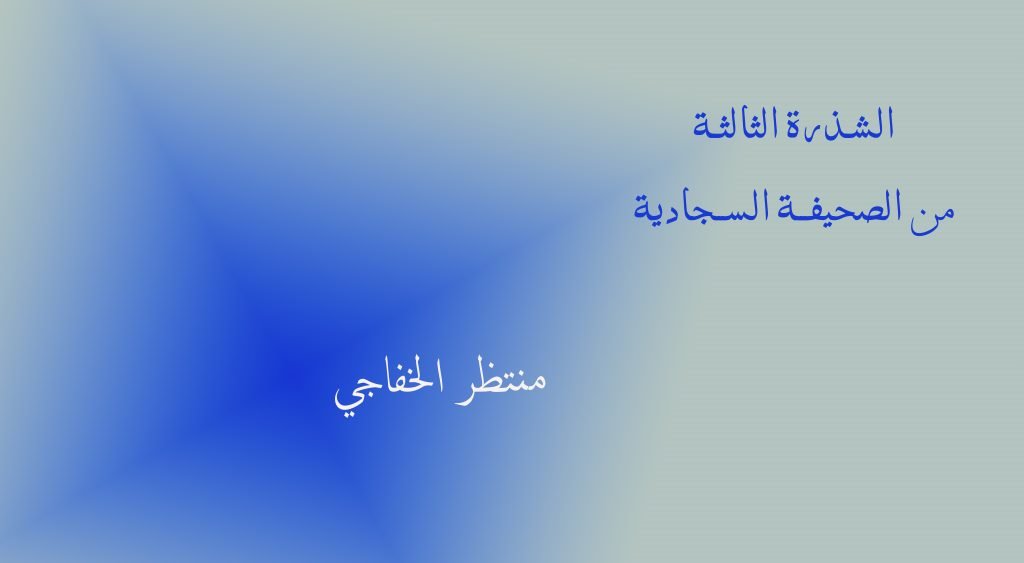
من دعاء الإمام السجاد في طلب العفو والرحمة
قوله: (فَأَمَّا أَنْتَ يا إِلهِي فَأَهْلٌ أَنْ لا يَغْتّرَّ بِكَ الصِّدِّيقُونَ وَلا يَيْأَسَ مِنْكَ المُجْرِمُونَ).
ها هُنا بيانٌ من الإمام زين العابدين -عليه السلام- لخُلقٍ الهيٍ رفيع وتعامل عميق، يتناسب والصفات الالهية الاولية؛ أعني بها الطبيعة الالهية أو قل الذاتية.
فقول الإمام (أنت يا إلهي أهلٌ) أي أن هذا الامر من أهلية الحق تعالى وما هو عليه بذاته وطبيعته التعاملية مع الخلق توجب على أعلاهم وأدناهم أن لا يتغافلوا ولا يتجاهلوا ولا يركنوا الى أعمالهم وفضائلهم ومحاسن صفاتهم؛ بل قد يُهلِك الصدّيق غروره بتصديقه أو بسيئة أحتقرها لصغرها.
ومن الجهة الاخرى، فأنت يا إلهي الأهل والمَحل؛ بأن لا ييأس من رحمتك والتفاتك وعطاءك المجرمون والمذنبون، فقد تُعطي للمجرم ما يأس من نواله، وقنَط من حصوله، واستبعده عن خياله وعريض آماله.
وللتعامل بهذا الخُلق جهتين:
الأولى: التعامل به مع الحق جل جلاله.
فعلى الصدّيق – والذي هو كثير التصديق بالحق- مهما بلغ من درجات الكمال ونتائج الاعمال وقدّم عظيم التضحيات أن لا يفرح ولا يغتر بأعماله ولا يَعظُم في عينه بنيانه ولا يُكبِر تضحياته وتقدماته فتكون سبباً في غفلته ونسيانه، فلا تعلم بأي ميزان توزن ولا بأي عينٍ تُنظر، فربما هدم البنيان العظيم الخطأ الصغير، فلا يشفع عند أهل العدل الأمر الكبير في محو ما يظنه صغير.
ومن زاوية أخرى أن لا يغتر أهل الله من الصديقين والاولياء بل والانبياء وغيرهم من أرباب الطبقات العليا بما يرونه من محبة الله لهم واختصاصه بهم ورعايته الخاصة لهم، وما يعيشونه من الطاف الحق العليا وفيوضاته العظمى؛ فإن كل ذلك ليس داعية للإغترار ولا محلاً للإفتخار، إنما العاقل من كان على حذرٍ من ربه في حسناته كما في سيئاته، فربما تبدلت الحسنة بالسيئة كما تتبدل السيئة بالحسنة، والعارف الحَصِيف مَنْ إذا اطاع ربه رجاه وتذلل له لقبول طاعته، وإن ناله عطاء من ربه أخذه بخوف وحذر من نفسه وتصويراتها، ولا يَنسب ما يختصه به الحق لخيرٍ صدر منه أو استحقاق أستحقه، فقد ورد في الأثر أن يوسف الصدّيق دعا الله تعالى أن يفرّج عنه كربته فقال: ( أسئلك بحق آبائي وأجدادي عليك إلا فرجت عني، فأوحى الله إليه يا يوسف وأي حقٍ لآبائك وأجدادك عليَّ؟!!!)[1] فينبغي على أهل القرب والكمال أن لا يروا لهم خصيصة عند الله تعالى إنما يفعل الله ما يشاء، فكم من وضيعٍ رفعه الله عز وجل وكم من صالح وولي أحطه الله وانزله من مقامه، وابليس أوضح مصداقٍ لذلك فقد أهلكه اغتراره بقربه من ربه وعلو منزلته.
ويُبيّن الإمام زين العابدين في مقاله من أن الارادة الالهية أعلى من أن تدركها العقول وإن التصريفات الربانية أخفى من أن تنالها مقاييس العباد، فلا يمكن تقدير وتخمين ماهيّة استقبال الحق تعالى للفعل الذي نظنه صالحاً، كذلك لا يمكننا تخمين ردّ الحق على الفعل الطالح، نعم المقاييس الأولية معروفة ومُمضاة في مراتبها لكن الإمام يتكلم عن نقطة أعمق من المقاييس والمعايير الأولية فلا تختلط عليك الأمور.
فعلى العاقل الذي يروم التعامل مع الحق تعالى بهذا الخُلُق أن يقدّم طاعته للحق كمن قدّم معصيته؛ بل هذا هو الواقع فكل ما تقدمه للحق تعالى من طاعات وتطوعات وتضحيات كلها ملوثة بلوث نقصنا وأوساخ تدني صفاتنا، وما يعطيناهُ الحق مقابل ذلك هو تفضل منه وليس استحقاق منا.
قوله: (وَلا يَيْأَسَ مِنْكَ المُجْرِمُونَ) فإطلاق كلمة المجرمين تعم اصحاب الذنب الصغير والكفر العظيم، فقد ييأس الفرد من رحمة ربه بسبب كثرة ذنوبه وظلمانية قلبه وهو من سوء الظن بالله تعالى والجهل بعظيم تسامحه وغفرانه، قال تعالى مخبرنا عن موسى عليه السلام: (قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)[2] وقد وعظني شيخي (قدس الله نفسه) قائلاً: (إن في إطالة الاستغفار سوء ظنٍ بالغفّار، استغفر عن الذنب وتيقن المغفرة ….).
فالحق تعالى له الأهلية المطلقة بعدم اليأس من رحمته وغفرانه وعطاءه، فمهما بلغت الخطيئة عِظَماً وكَبُرت الجريرة حجماً، فاليأس من غفران الله أعظم منها ذنباً.
الجهة الثانية: التعامل بهذا الخُلُق مع الخَلق.
كما قلنا في الشذرات السابقة أن بيان الإمام لهذه التعاملات والاخلاق الالهية هو لأجل أن نتخلق بها ونعتمدها في تعاملاتنا ونجعلها من مرتكزات أفعالنا. وإن أعظم العبادات وأنفع الطاعات للتقرب من الحق تعالى هو بالتشبه به من جهة الممكنات أي الافعال والصفات. فعلى من أراد أن يطأ هذه المرتبة القربوية والمكانة الكمالية؛ أن يكون أهلاً لئلا يغتر به القريب منه أو من يرى نفسه أهلاً للتبجيل والتعظيم، فلا يُسقط خطايا أهل المراتب لأجل مراتبهم وأهل الاصلاح بحجة إصلاحهم وإنما يكون أهلاً للعدل حين وجوبه ولو كان على أهل الاصلاح واصحاب المنازل الرفيعة سواء الدينية أو الدنيوية، ولا يجعل لإغترارهم نصيب من مجاراته ومداراته، إنما يكون أهلاً ومحلاً للإنصاف.
ومن الجهة المقابلة عليه أن لا يُيئِّس المذنبين والمُقصّرين من عفوه ورفده، فربما أيِسَ المذنب من عطاء الكريم فأبعده يأسُه والنظر لذنوبه وفسوقه عن ساحة العطاء وباب الرجاء، فشارب الخمر مثلاً هيهات أن يطرق باب رجال الدِين حين الاحتياج؛ لأنه متيقن من الطرد والإبعاد.
فعلى صاحب هذا الخُلُق قتل روح اليأس عند المجرمين وإزالة غشاوة البُعد عن المذنبين، فلربما استحق المجرم بحسنةٍ واحدة صدرت منه ما لا يستحقه الصالحين. فاجعل باب قلبك مفتوح لكل طارق كما باب رحمة ربك مُشرّع لكل واردٍ وهارب (كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا)[3].
فلا تجعل من الخارج دافعك ومانعك، فقد يصمّ مسامعُك عما يُقرره باطنك.
منتظر الخفاجي
6 رمضان المبارك 1445
[1] – تفسير القمي- علي بن إبراهيم- ج1 ص 353
[2] – سورة القصص / الآية 16
[3] – سورة الإسراء/ الآية 20




