الباب السابع
باطن النظام الإلهي والنظام الباطني الإلهي
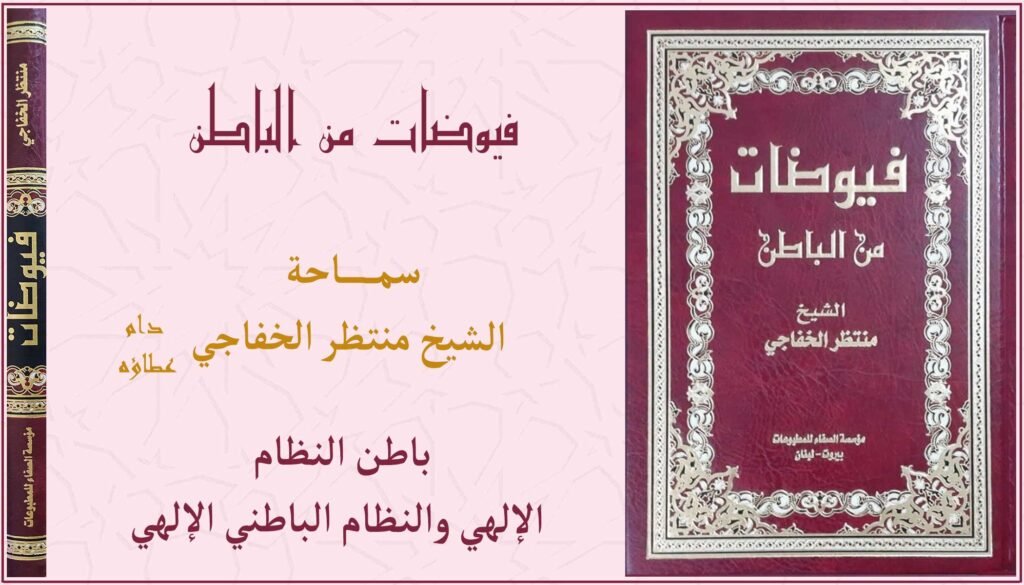
إن الانحـراف عـن النظام الإنساني يُعد خروجاً عنه، والذي بدوره إما أن يحـدث إخلالاً في النظام أو في المنحرف عنه أو كليهما؛ وسبب ذلك هو محدودية النظام الإنساني لتقيّده بالدواخل الإنسـانية، حيث إن صدوره والمتحكم به هو مجموع جوانب الإنسان، فكان لكل جانب حظ في تكوين هذا النظام، وهذا ما أنتج قصراً في عمر النظام واستمرارية التعديل فيه، فما يصدر من الناقص ناقص لا محالة، هذا شيء.
والشيء الآخر هو أن النظام الموضوع من قبل الإنسان متكون من خط واحد، فالانحراف عن هذا الخط يُعتبر خروجاً عن النظام إلى اللانظام والذي وجوده يدل على محدودية النظام وقلة مساحته، هذا بالنسبة للنظام الوضعي.
أما النظام الإلهي فإنه على العكس من ذلك، فالانحراف عنه لا يُعد خروجا منه، حيث تكوّن النظام من خطوط متعددة؛ بل أن بعض خطوط النظام الإلهي متقاطعة دون الإخلال بنظاميتها فكل خط هو نظام وإن كان معاكساً أو متقاطعاً والخط الأخر، وهذا من عجائب التنظيم، وليس عـلى الوضع التنظيمي الإنساني المبتني عـلى الترتيـب الواحد.
فالانحراف عن النظام الإلهي هو خروج من الخط المرسوم للمخلوق إلى خط آخر في النظـام، أما الخروج من النظام الإلهي فهو محال لأنه خروج عـن سـيطرة الحق تعالى. وهذه الأنظمة والخطوط الفرعية هي في تفاوت مـن ناحيـة الكيفية والمنهجية، وكذا الصعوبة والسهولة التطبيقية، وان الأنظمة الإلهية حسب ما تبين من أنها تفوق كل احتمالات العقل حين الاستقراء!
وتَعَـدّي حدود الله هو تعدّي حدود النظام الذي رسمه الحق لذلك العبد، أي يخرج العبد من النظام الكمالي التصاعدي الذي أراده الحق له، وحينمـا يخـرج العبـد إلى خطٍ هو أدنى من خطه واقل حظاً من الأول يكون قد تجاوز حدود الله.
أما عند الترقّي فإن الفرد لا يبقى في خط واحد، نعم يسير في ذلك الخط النظامي ربما إلى نهايته؛ لان لكل خط كماله الخاص المُكتَسب ممن هم فيه، فينتقل إلى خط أعلى مـن السـابق مـن اجل استمرار كماله، هذا عند الرُقي النوعي لا كل رقي. وكـل هذه الأنظمة والخطوط غايتها الوصول بالإنسان الكمال المقرر، وهذا يعني ان الإنسان دائمـا فـي زيادة مستمرة ملحوظة أو غير ملحوظة وهو دليـل عـلى الكمـال العـام. وقد وضع الحق لكل موجود مجموعـة من الخطوط التي لا تحصى تحت أُصول الأنظمة لاحتمال خروج الموجود إلى خط غير خطه، حـيث العـوامل الباطنيـة فـي تحـكّم وتحّول مستمر حتى في أوقات زمنيـة قليلـة، فأحيانـاً يتغـير الطابع الفعلي للإنسان فيوجـب الحق التحـول الباطني إلى نظام يناسب ذلك التغـير، فكل حركة أو سَكَنَة تقع تحت نظام معيّن. أما مع عدم وجود نظام أو خط نظامي لفعلٍ ما فهـذا يعني انهيار النظام الإلهي العام.
وكل هـذه الخـطوط لهـا تـرابط دقيـق عـلى الرغم من رؤية الإنسان العكس أحيانا، فقد يرى تناقضاً بين الأنظمة، نعم التناقض يمكـن أن يقـع في أفعال النظام لا في النظام عينه فمصدر الأنظمة واحـد ومصبها واحد، وغالبا ما يكون الترابط فعلياً بين نظام وآخر أي بفعل معين يكون له مسـتويان مـن الفعليـة فيتصـل بالنظام الأول من المستوى الأول وبالنظام الثـاني من المستوى الآخر، فيكون رابطا وجسرا للانتقال من نظام إلى أخر، حيث بعض الأنظمة لا توصل إلى تلك الغاية مباشرة، إنما تتصل بخطوط أخرى هي التي توصل إلى الغايـة إن كـانت الغايـة جزئيـة أو متناهية، أما لو نظرنا بعين المعنى لوجدنا أن الخطوط عبارة عن سلسلة تـوصل إلى الكمـال وليس لأحد منهـا أن يـوصل إلى الغاية مباشـرة! وان كان هذا من أسرار النظام الإلهي. لهـذا نـرى كمـالات المريد تخـتلف على حسب اختلاف التكاليف التي تصل إليه، المستسقاة من المقامات المركوزة في النظام الباطني والتي تحتاج إلى استعدادات مختلفة حسب كل مقام والذي يختلف عما يليه تنظيما ويرتبط به من أحد مسـتوياته وان كان الخط العام واحداً.
والدخـول فـي نظـام أعلى من سابقه يعتمد على معرفة خطوط النظام الأول بالمعرفة العملية الرافعة للمستوى النفسي والخيالي العقلاني للإنسان، فلو أن إنساناً أخل بنظام الشريعة مثـلا وهـو من ابسـط الأنظمة الكمالية لكل إنسان والركيزة الأولى للبشرية فانه سوف يدخل في نظام أخر غير النظام الموضوع لمن أتم نظام الشـريعة وعندها يكون الانحراف التدريجي، والذي يزداد حتى يصل إلى متاهة تحجبه عن الوصول إلى المرحلة الكمالية الأخرى التي مـن اجلهـا وضعـت الشـريعة بأصولهـا وفروعها. ولكن الإنسان يسـتمر بـذلك الانحراف على أساس الصحة ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ |الكهف104:|! والسبب هو انه يرى نظاماً قائماً ومترتباً في خطوطه، فعندها يعمل الوهم النفسـي المبتغي لبقاء الإنسان في نفس النظام الموجب للتسافل والانحراف إلى النظام النفسي التكاملي في خط الظلام، ولكـن باسـتطاعة الإنسان تلافي ذلـك إذ ﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ |الحديد: 4|.
وأعلم أن لكل نظـام حـدوده، فلا خروج منه إلا بالإرادة الصادقة الكاشفة لنقطة الترابط بما فوقه، لذلك نرى أن الإنسان الذي يسير في الظاهر لا يُكشف له الباطن حتى لو وصل إلى ذروة الظاهر، لان لكل شيء أصلاً، وكما نَبَهَنا إلى ذلك شيخنا (أدام الله فيضه) حيث قـال: (لا تنظر بعيـن من يَرى أن القشور تحفظ الجواهر، بل انظر بعين من يرى أن القشور تحجب عن الجواهر) فالزاهد مثلاً لا ينال من المعرفـة شـيئاً حـتى يدخل في ذلك النظام، لأنّ في الزهد يتدرج تصاعديـاً حـتى يصـل إلى أعلى مـراتب الزهـاد ثم يدخل في نظام يشـابه نظامـه السـابق إجمالا ويخالفه تفصيلاً، أي يكـون مسـيره باسـتقامة واعني الاستقامة الظاهرية منها، علما أن المطلوب من الاستقامة هي ليست استقامة المسير إنما استقامة الخـط الكمـالي والذي يكون مسيره في نظام متوازٍ لا باستقامة ظاهريـة وهـذا واقـع الاستقامة عند التحقيق بالكشف الحقي.
فالاختلاف بيـن مقام الزهد وما يشابهه في التفصيل هو من رفعة المقام الآخر لا غير فلا يدخل إلى المعرفة. أما لو عرف حقيقة الزهد بعـد الكشف بالفيض النوراني فانه يكون باباً من الزهد إلى المعرفة فيستطيع من خلاله العبور إلى نظام المعرفة عند الاسـتعداد القلبـي والنفسـي الموجبين للسيطرة على الأوهام النفسـية واليقيـن المنتظر.
أما بالنسبة للخروج إلى النظام الأدنى فان الزاهد يمـر بتمحـيص مثـلاً أو اختبار فيبقى في نفسه شيء يوجب اختلاف نيتـه فيتحـول زهـده إلى تزهـد وهنالك يكون الخروج إلى النظام الثاني أي نظام المتزهدين مـع بقـاء المسحة الزهدية! التـي سوف تحجبه عن معرفة انحرافه أو حقيقة انحرافه.
واعلم: أن هذا الحجاب هو من وضع الإنسان نفسه، فيبقى في ذلك مع العلم بأنه انحرف عن النظام أو تعدى حدود الله، لكن هذه المعرفة في بعض الاحيان ليست بالمعرفة المنتجة لليقين الموجب للخروج عن حاله والرجوع إلى نظامه الأول.
أما الرجوع في النظام، فان الإنسان إذا وصل فـي نظـام معيـن إلى مرتبة ما من الكمال ثم أهمَل أو أخل بشيء من ذلك بخللٍ معتدٍ به فمن البديهي سوف يتسافل، ولا يكون رجعه في نفس نظامـه الأول وأعني ما تصاعد به، فإن دَخَلَ التوكل والرضا والتسليم وتجاوزهـا فعنـد انهيـاره لا يرجـع إلى التسليم فالرضا فالتوكل؛ بل يسلك نظاماً آخراً رجوعياً، فمن اخل بالمرتبة الأولى من مـراتب التوحـيد مثلاً سيكـون خروجه إلى النظام التنازلي الموازي أو المساوق الذي يكون على درجة استحقاق الموحد، وهذا من الآثار المترتبة عـلى خرقـه للنظـام، لهذا يكون التسافل سريعاً جدا. وكذلك فإن للخطـأ أضرارا عديدة وليس ضررٌ واحدا كما هو ظاهر. ومثال ذلك، إن المريد حسب النظام الباطني يجب أن يستنزل معارفه عن طريق الكشف الحقيقي فإن أخل بذلك وأخذ معارفه عن طريق الكسب كالدرس أو الاطلاع فسيخلّف ذلك أضرار كثيرة من هذه الاضرار:
أولاً: إن هذه المعرفة الكسبية ستحجبه عن المعرفة الحقيقية الذوقية والتي توصل إلى مقامها، فسوف يُحجب عن معايشة المعرفة وعن بلوغ مقام تلك المعرفة، فتكون معرفته معرفة عقلية صرفة دون أي فائدة كمالية حقيقية، فيتحول من نظام طالب الكمال إلى نظام طالب العلم.
ثانيـا: لـو أخذها عن طريق الكسب فسيتوقف استعداده لأخذ غيرهـا. وذلـك، لان المعرفـة الأولى تولد استعداداً للحصول على الثانيـة فعندها يفقد الاستعداد الثاني للحصول على المعرفة الثانية على الوجه المطلوب فيُحجب عن المعرفة الأخرى.
ثالثا: سيولد له هذا الفعل استعدادا لأخـذ معرفة كسبية أُخرى حيث ملازمة الاستعداد للفعل، مما يؤدي إلى البُعـد التدريجـي عن النظام الموضوع له، وبعد ذلك ينتقل إلى نظـام آخـر، فالنظام على قدر الاستعداد، وبما انه ظلم اسـتعداده وجـب وضعه في نظام آخر على قدر استعداده الجديد.
ومن الطبيعي أن يكون النظام الثاني اقل مرتبة من النظام الأول فـي كمالـه المطلـوب، وإلا فمـن الممكن أن يكون أعلى في كمال آخر.
وكما ذكرنا إن بين الأنظمة الإلهية ترابط من جميع الوجوه للموجـود وبها تكون الرابطة مع الحق التي هي أقوى الروابط، لأخذ المد الإلهي، فيتحكم الإنسان بهذه الرابطة ويستطيع أن يمتنها بوضع نظام يكون منبعه من الحق وبتطوير أكبر يكون مصبـه إلى الحـق فيكـون منـه إليه معه.
أما بين الموجودات بالاسـتقلالية الوهميـة فـان بينهـا ترابطاً، لأجل اكتساب كل موجـود مـن أخيه، وأول هذه الـروابط هي رابطة التكميل وهي رابطـة بدائيـة يكون مـن خلالها تجـاذب الموجودات. وهـذا التشـابه الـرابطي والذي يعود لأصل التجـاذب هو الرجوع للأصل، فمن خلال ذلك يكون المد والاكتساب النـوعي وهـو يعتمد على القدرة الكمالية، فإن الإنسان السابق في مدارج التكميل يكون ذو قدرة اكـبر مـن الآخر وأعني القدرة بكل أقسامها، فيكون منـه الاكتسـاب ومنـه المدن وهذا يشمل الخطين التصاعدي والتسافلي، وتكون هذه القدرة على حسب كمال الشخص.
وهناك عدة أنواع من المد على مستوى القـدرة وقوة الرابطة. وكل هذه الأنواع تعـود إلى المد المعنوي لوجود الرابط، ولان الأصل في التحولات والتغـيرات الماديـة هي المعنويات، أي وراء كل مادي معنوي وهـو المحـرك له، فمن خلال هذا الترابط يكون المد المادي وهو الـذي يكون بيـن أفراد النوع الواحد إن كانت النظرة خصوصية أما لو تراجعنا للوراء لوجدنا ترابطاً أكبر من ذلك لكنه أضعف وهو بيـن الجـنس الكـامل مـن الموجـود.
إن هذا المد هو من العطاء المـادي بجـميع أنواعه ويتخـلله مد آخر وهو معنوي، والأول تارة يكون أولي وأخرى ثانوي:
فأولي: تكـون له فائدة معنوية سابقة للفائدة المادية أو متزامنة معها.
أما الثانوي: فإنه مجرد من الماديات مثـل المد العلمي الناتج من العاقلة النظرية، إذ إنه مد مجرد مـن المـادة. وهنـاك إمدادات إلهيـة أعظم مـن ذلك منها المد الاكتسابي التكـاملي الكـامن برابطة المحبة والشوق للكامل.
أما المـد المادي فينتج من النفس وذلك بِظل الصفة النفسية المعكوسـة من فعـلٍ بفعـلٍ معيـن. وهناك المد القلبي والعقلي ولكـل واحـد أقسام عديـدة ومسـتويات لا تُحـصر.
كما يوجـد من مسـتويات الـروابط مـا هو أدق من ذلك، ففي الماديات يكون هنالك تـرابط على رغم البعد المادي، فحد الموجودات ليـس من جـانبٍ واحدٍ فقط. فالنـار مثـلا لها ترابط مع الأشياء وذلك بالاتصال وهي رابطة تحـويل الشـيء نحـو الأسفل أو الأعلى أي بالإحراق، ورابطة أخرى هي ليسـت بالمباشـرة واعنـي بها رابطة الضوء المنعكس من النار فأنها تعطـي للأجسام البعيـدة دون ملامسة النار لهذه الأجسام، فالفـائدة للأشياء لا تقتصـر عـلى القرب، ومن يعلم لعل فائدة البعد اكبر من فائدة القرب! ، ولو نظرنا من جانب آخر للمثال مـع الدقة لوجدنا أن النار تنتج بعض الغازات التي لها فائدة لبعـض الموجـودات، أمـا لو نظرنـا من جـانب وجودها فإن النار قائمـة بشـيء آخـر، ولـو نُقِـل المثـال إلى الباطن لتبينت بعض الحقائق لأولي الألباب، فإن النظر من جوانب عدة هو الموصل إلى حقيقة الشيء لا النظـر من جانب واحد كمـا فعـل علماء الظاهر من الطبيعيين الذين حجـبوا بمعـرفتهم هذه عن معرفـة الحقـائق.
فالمد العطائي هو مــن الـروابط الأساسية بين الأشياء وهذا الترابط هو الذي يكون من خـلاله العبـور من نظـام إلى آخر، ويكون به الدخول في النظام البـاطني الخـاص كما بيّن الحق تعالى هذا الترابط وبيّن العبور من نظام إلى آخر في المنهج الذي حواه قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ |طـه82:| فإن لهذا المنهج نظـاماً معنـوياً وضعـه الحق يوصل إلى غاية سامية وهي الغفران، فالهـدف هنـا هو الغفـران، أي إن هذه النقطة هي الغاية الكمالية الاستقلالية لخـط النظام هذا، والمقصود من الغفران هنا هو المستوى المتقـدم منه أي غفـران الصفـات النفسية، ومحو الصفات المكتسـبة مـن الأفعال الظلمانية ثم إشراق نور صفات الجلال، فيكون الوصول لنيل الغفران بنظامه الخاص وهو الموجود هنـا، فمـن اقلـع عـن الأفعال وتنزه عن الصفات التي تفرز الحجب الظلمانية، وتاب غاية التوبة بعدم الرجوع إلى الاعتماد على الصفات والاعتقاد بحقيقتها، وآمن الإيمان القلبي بعد الاغتسال المعنـوي التام الموجب لليقين، وعمـل صالحـاً، أي عمل بما كُشف له في درجات التلقي البـاطني مـن الأعمال الموجبـة لمحـو الصفات المؤهلة لمحو الـذات، ثـم اهتـدى لطـريق معرفـة سـر الحقيقـة بالاستعداد البـاطني المـودَع فيـه، عندهـا يكون الغفران الكلي، حيث انصهار النفس بالكليـة لِتَحـكم الصفـات الحقـة، بوجود الاستعداد لتجلي الصفـات، وقـدّم الحـق الغفـران في الآية حـيث يستلزم دخول النظـام معرفـة الهـدف، وللهدف قوة دافعة لخلق استعداد لدى الإنسان والوصول لهذه الغاية بدخول هذه المدارج من النظام.
فهـذا مثـال عـلى ترابط النظـام المعنـوي التكـاملي للإنسان والعبور إلى النظام الباطني.
أما النظـام الآخر، وهو النظام الطبيعي، فمنه نظام تكوين وتكامل المعادن الموجودة في الأرض والتي أصلها التراب، حيث مرورها بمراحـل خـاصة بها كي تصبح من خلالها معادن ذات منفعة وقيمة كبيرة، فإن أخلّت بالنظام المرسوم لها خرجت عن غاية النظام وتحولت إلى نتيجة أخرى فبدل أن تكون ذهباً تصبح نحاساً مثلا.
وعلى كل الأنظمة يجري نظام التحول من شيء إلى آخر سواء كان التحول مادياً أو معنوياً.
(وسبحان من سخر لنا هذا)


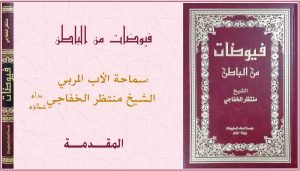
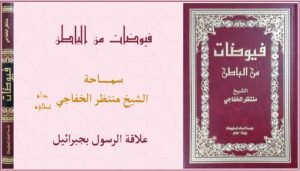
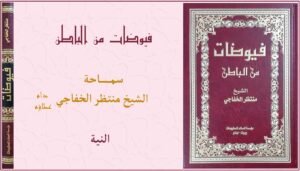
ادامك الله تعالى ذخرا للبشرية جمعا.
ادام الله تعالى وجودك