الباب الثاني عشر
فيضٌ من باطن قضية الحسين عليه السلام
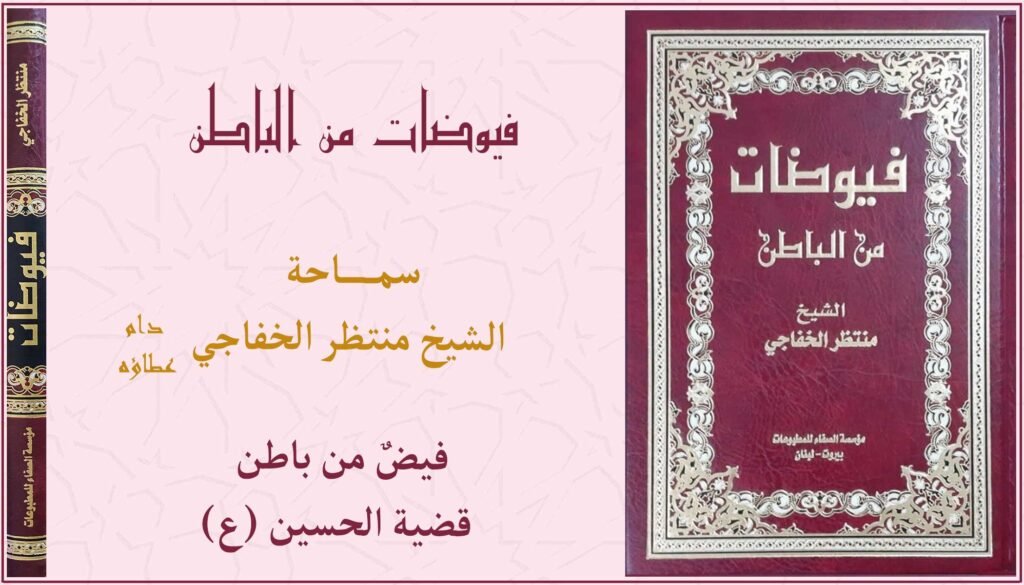
بما أن أصل الوجود هو الوجود المعنوي، ثم أفاض الوجـود المادي، أخذت الموجودات من معنى ذلك الوجود وصفاته، وكان ذلك هو الصلة الباطنية الأولى، أعني صلة الموجودات بموجدها وهي صلة الرجوع للأصل وهي معنى الوجود وما اكتسب من صفاته بالاكتساب المقصود، وإلا فالوجود ليس له صفة. وعليه كان لكل ظهورٍ أبطنة، ومنه كان لقضية الحسين [ ع ] باطن على قدرها، وإن كان الرائي يرى منها قضية ظاهرية جاءت من أجل تثبيت أمور ظاهرية ليس أكثر، لكن هذه الرؤية سببها إن الغالب على الإنسان الميل إلى جانبه المادي والظاهري أكثر من ميله إلى جانبه المعنوي والباطني، لذا ليس له منظور إلا المنظور المادي، كما وصفه تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ |الأعراف: 176| أي رضي بالمرتبة الدنيا منها وركن إليها فحُجب عن باطنها وبَعُد عن معاليها. لكن هذا لا ينفي الوجود الباطني ولا يرفع الظواهر عن كونها أبواباً للبواطن.
والناظر الملتفت لقضية الحسين [ع] يرى لباطنها من العمق والسعة ما لا يقاس به ظاهرها، وإن الفوائد التي حققتها للعالم المعنوي ما تسقط أمامها كل الفوائد الدينية والدنيوية. فإن لهذه القضية باطناً أعمق مما يتصور حتى صاحب الباطن.
ومما نستطيع الإشارة إليه شيء يسير من المرتبة الأولى فحسب، أما غيرها من المراتب فتلك تؤخذ بالكشف والفيض . فنقول وعلى الله التٌّوكلان.
إن من باطن قضية الحسين [ع] أمرين :
الأمر الأول: فائدتها للباطن، وهو على مستويات:
المسـتوى الأول: في ظاهر الباطن، فإن للبـاطن أبواباً فـي الظاهر. وقضية الإمام أصبحت من أوضح الأبواب للدخول إلى الباطن، وأسرع الابواب كمـالاً، فقـد فتـح الإمام الحسين [ع] فتحاً مبيناً جديداً للباطن، فكان في قضيته توسيعٌ في ظاهر الباطن.
المسـتوى الثاني: إن قضية الإمام الحسين[ع] كانت نقلـة فـي الاسـتعداد العـام، إذ أن المسـلمين كانوا أصحاب اسـتعداد متـوقف منـذ استقرار الرسالة المحمدية حـتى واقعـة الحسـين [ع] فكانت هذه القضيـة هـي أسلوب مـن أساليب اسـتخراج الاســتعداد لكافــة المسـتويات سـواء كـانت ذات المسـير فـي الكمـال التصـاعدي أو التكامل التنازلي، فكــانت الخــطوة الثانيــة في الإسلام. وفي الثاني كمال الأول وإن كان يرتكز عليه.
المسـتوى الثـالث: إن هـذه القضيـة هي من أكبر الاختبارات التي مـرّ بها المسـلمون، فكانت اختباراً لعامة المسلمين ولخاصتهم أي أعلاهم يقينا وأدناهم، فسعد من سعد وشقى من شقى.
المسـتوى الـرابع: وهو من أسرار قضية الحسين [ع] فإن هذه القضية أفادت في كمال العرش وكل ما دونه، فكانت إشراق على المجردات والحقائق العليا وغيرها مما هو أعلى وليس محله كتاب.
وليست قضية الحسين [ع] حرباً ظاهرية ثبت بها الدين فقط؛ إنما هذا أمر زهيد أمـام الفوائـد التـي قدمهـا الحسـين لدائرة الوجود.
وليس هذا عليهم بكثير، فإن الحـق تعالى اعتمـد في طريق الكمال على الأئمة عليهم السلام منـذ بـداية الخلق وحتى نهايته، فكانوا ولاة أمره على دينه وخلقه وخلفائه على أرضه، وهذا ما اقتضى أن يلازموا عملهم إلى نهايته، وإلا فـلا قيـام للإسلام وغير الإسلام ظاهره وباطنه دون وجود إمام معصوم، لتعلق كل الديانات بولايته.
وبـذلك يقـول الإمام الصادق [ع] بما معناه: (نحن الأئمة موجودون في كل زمان ومتى ما انتهت حاجة الله من خلقه رفعنا إليه).
الأمر الثـاني: هـو فـائدة الإمام الحسـين [ع] من قضيته وهي على جانبين ويرتبط بهما جانب ثالث:
الجانب الأول: فائدة أصحاب الحسين [ع]. فاعلم: إن أصحاب الحسين من الحسين، فإن الإمام في الباطن يُعد أصلاً يتفرع منه فروع عدية، فكان أغلب أصحاب الحسـين عليه السـلام هم فروع منه، أي أنهم كمالات جزئيـة مكتسـبة من الكمال الكلي وهو الحسين[ع] حيث أن أصحابه [ع] كلهم كانوا في درجة الفناء في الحسين [ع] إلا اثنيـن وهمـا عـلي الأكبر والعباس فان فنائهما كان بالله.
وحـتى العبـاس والأكبر همـا كذلك فروع من الحسين [ع] ولكن اخذوا استقلالهم في عالم المعنى بوصولهم للفناء.
فكان لأصحاب الحسـين الفائدة الكبرى من هذه القضية، إذ أنهم اكتسـبوا بهـا عظيم الكمـالات المكتسبة من كمال الحسين المستفيضة من الكمال اللامتناهي، وأعني الذات المقدسة.
لأن رابطـة المحبـة للكمـال أو الكـامل موجبـة للاكتســاب من كمالـه على قدرها. إذ انها أكبر الروابط لخلوصها وتجردها من المصالح، واعني بها المحبة الحقيقية. لذلك نرى أن المريد إذا أحب شيخه أسرع في طريق الكمال.
واعلم: إن أصحاب الحسين لو يعملون طوال حياتهم؛ لا بل وحيوات أُخر لَما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بمشاركتهم في قضية الحسين.
الجـانب الثاني: هو فائدة الإمام الحسين [ع] نفسه، فأقول: حسب ما تبين لنا أن خـروج الإمام الحسـين [ع] لـم يكـن بأمر الهي إنما كان بإرادة الحسـين [ع] الخالصة، وان شاء الحسين [ع] تخلى عن ذلـك. وهذا لا يكون إلا لمن أبصر النظام وأدرك الحكمة وما يريده الحق تعالى على مستوى الواقع، فأقبل عليه السلام على هذا الفعل لرؤيته احتياج النظام الإلهي إلى ذلك. فكان عليه السلام مع النظام الإلهي كصاحب الدار في داره أو الملك في مملكته فلا يحتاج صاحب الدار إلى حافز خارجي كالتكليف وغيره لأجل أن يُقدّم الأصلح لداره. وأما التكليف فعادة يكون لمن لا يدرك المصلحة وللضعفاء المفتقرين إلى الدافع الخارجي. لكن الحسين [ع] بعلو مقامه اعتبر كل ما فيه مصلحة للخلق هو تكليفه، وهذا من الأمور التي يصعب على غير المعصوم تحملها، إذ أن مقام العصمة تصاحبه مسؤولية كبيرة يندر تحملها.
ولم يكن خروجه من أجل تحصيل الكمال الخاص، أي رُقِيه في مدارج الكمال وإنما كان للمصلحة العامة العليا كما أسلفنا. نعم نال الحسين كمالات من خروجـه، وكان في خروجه سـرعة في كمالـه، وقـد وصل [ع] بقضيته إلى معرفة الحق التي عرفه الرسول بها. لكن حسب ما فهمنا أن ذلك لم يكن بحسبانه عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام، إنما كان نظره على ما اقتضته المصلحة العليا.
أما الجانب المرتبط بهذين الجانبين وهو:
الجانب الثالث: إن هذه القضية أفادت أعداء الحسين بكل مستوياتهم.
فبقبولهم محاربة الحسين فُتح باب من أبواب كمالهم، وهو التسافل في خط الكمال، أو قل التكامل في عالم الظلام، فقد كان لقضية الحسين طفرة كمالية لأعدائه في كمالهم حيث وصلوا إلى مراتب سحيقة في عالم التسافل. ومن جانب آخر فإن من أعداء الحسين من كان في حيرة من أمره، أي متأرجح بين الحق والباطل وهؤلاء هم أصحاب قول: (قلوبنا معك وسيوفنا عليك) فحسم الحسين أمرهم وأعطاهم استحقاقهم وهو التسافل، فجمع قلوبهم إلى سيوفهم، لأنا نعلم أن الاختبار أو التمحيص له ثلاثة نتائج لا رابع لهما وهي: أن يرفع من كمال الصالحين، ويحط من كمال الطالحين، ويحسم أمر المتأرجحين، فكذلك كان عمل قضية الحسين عليه السلام.
فقد أعطت هذه القضية دافعاً وتحريكاً لكل الأنظمة الإلهية، لا لخط الكمال التصاعدي فقط. واعلم أن هذه الثمرة تستحق أن يضحي الحق بمئات الأنبياء من أجلها لا بحسين واحد!…
أما بالنسـبة لمقتلـه [ع] فإن نظرنا من زاوية أخرى، فإنـه قـد حوى أكبر المصـائب وأصعب المواقف التـي لـم يمر بهـا غـيره على الإطلاق، وقد بُيّن لنا (أن سـليمان طلب من الله مُلك لا ينبغي لأحد من بعده، والحسيـن طلـب مـن اللـه مصيبة لا تنبغي لأحد من بعده). وهذا منتهى ما تصل إليه البشرية من تحمل ومنه وعلى الرغم مما مر به من مواقف لم يخرق النظام الطبيعي وهو صاحب الولاية الباطنية العليا، ولو شاء لجـعل عاليهـا سافلها.
أما بالنسبة إلى تضحيته، وهي أعلى التضحيات، فاعلم: أن تضحية الحسين لم تكن عشوائية؛ بل كانت مرتبة ترتيباً تكاملياً، يوصل إلى ما أراده هو [ع] أو ما اقتضته المصلحة. فمن ذلك جلب عياله معه، الموجب للإيذاء أن لم يكن القتل، وقد مات بعضاً منهم من شدة العطش، وان أغفل التأريخ ذكر ذلك.
الشيء الآخر هو تقديم أصحابه وأهل بيته واحدا تلو الآخر، وإلا فكان بمقدوره أن يهجم هجمة واحدة وينتهي الأمر، لكن لو حصل ذلك فسوف يُنقص من كمال قضيته، واقل نقصاً هو أن يقصّر عمرها، فقدمهم [ع] واحداً بعد واحد، وهذا ما جعل المصيبة الواحدة تفوق السبعين مصيبة، ومنه كذلك قتل الرضيع، والذي الطفل يختلف عن البالغ من جهة العاطفة الأبوية بأمور، منها أنه يأخذ من عاطفة الأب أكثر من البالغ حيث عدم ادركه للأمور، وليس له أن يقرر مصيره على العكس من البالغ، أضف إلى ذلك تألم الطفل من شدة العطش مع عدم القدرة على الإفصاح عن ذلك مما يجعل ذاك حسرة في قلب الطفل المؤدية إلى زيادة عطف الأب عليه، إلى غيرها من أمور هذا الرضيع التي يصعب تحملها عند السماع. لكن هدف الحسين كان أسمى من أن يعطف على رضيع أو كبير، لان عاطفته كانت عامة لكل المسلمين، بل لكـل البشرية، لهذا كانت تضحيته لأجل الكمال العام.
وقد ضحى عليه السلام بكل ما يتصل بـه مـن قـريب أو بعيد، بكل عزيز من أصحابه إلى نفسه وحتى ملابسـه [ع]، فخروجه من الدنيا لو صح التعبير ليس كما دخل فيها؛ بل اقل مما دخل؛ فقد دخلها بجسدِ تام لكنه خرج بجسد مُقّطّع.
أما استشهاده فكان منه حدٌّ لهذا المقام، فإنه [ع] حـدَّ مقام الشهادة بحده الأعلى، ومقام الشهادة متناهي الدرجات، وليس هو أعلى المقامات، إنما هو الأعلى على مستوى مقامات الظاهر المقامـات بالنسـبة لأصحاب الظـاهر، أما في البـاطن فهنالك من المقامات ما هو أعلى من الشهادة. فوصل الحسين [ع] إلى كمال مرتبة الشهادة وليس لأحد من البشر أن يبلغ أعلى من ذلك لعدم وجوده.
وكـذلك فتحت هذه القضيـة بابـاً واسعاً، في عالم الاتصـال بالأئمة (ع) والوصول للكمال عن طريقهم، وأصبح من خلالها الحسـين أسرع الطرق للاتصال بالله جلّ وعلا؛ أي أسرع من بقية الأئمة ~عليهـم السـلام~ وانعكس ذلك على مستوى الظاهر فإن من خصوصياته [ع] أنه يقبل زيارة كل زائر، عـلى العكـس من الأمير [ع] فانه لا يقبل إلا الخاصة، وهذا يُعكَس على الآخرة، فيكون هو الشفيع الأكبر للناس على وجه الظاهر بعد الرسول (ص).
هذا، وقد اتصـف الحسـين [ع] بصفتين من أصعب صفات الحق وهما صفتا الوحـدة والغربة، فتجسدت هـاتان الصفتان بقالب الحسينu] [ ولم تعتريه صعوبة في حملهن، فكان اكبر ما تجلى الحق بالحسين [ع] عند تلك الواقعة.
أما بـاطناً، فان الإمام الحسين [ع] لم يكن وجوده في المعركة بـالوجود الحـقيقي، إنما وجـوده ظاهري، أي كان في حال تجرد تام، وأعني بالتام تجرد نفسي وقلبي وعقلي. فلـم يكن موجوداً بالوجود الكـلي، ولكنـه لـم يخـرق النظام النفسـي الظاهري، فلو صحت الروايات عن بكائه أو تألمه [ع] إنما كان ذلك من اجل حفظ الظاهر، وكذلك من اجل زرع الألم الذي يساعد على المسير فـي التكـامل.
ومن الأمور الكمالية الكبرى التي حققها [ع] لأهـل الباطن والمعرفة، هو انه بيّن للعارفين على مر الأجيال أن الإنسان يستطيع أن يختصر خط الكمال، ويستطيع أن يُنزل العـطاء بإرادته. والأمر الثاني الذي بينه الحسين من خلال قضيته هو تجنب العمل بما يخرق النظام الطبيعي، حيث كل العارفين يدركون أن الأرض لا تخلو من ولي يتقلد مقاليد الولاية الباطنية العليا، وقد كانت لدى الحسين [ع] وهذه الولاية هي المقصودة بأن لا تكون إلا لشخص واحد، وإلا فالحسين في زمن الحسن عليه السلام هو ولي لكن ليست ولايته هي الولاية العليا إنما ولاية باطنية جزئية، فإنه يستطيع أن يؤثر بالكون من خلال باطنه المؤثر والمهيمن عليه. والنتيجة انه عليه السلام أسدل حجاباً على تلك الولاية، وسار وفق النظام الطبيعي، وهذا الباب هو ما دفع ببعض أهل الباطن -رضوان الله تعالى عليهم- إلى ترك طلب الكرامات من الحق، فأن أُعطوا تركوا العمل بها، حتى قال شيخنا -أعلى الله مقامه-: {لو عرضت عليّ الولاية الباطنية العليا لرفضتها}.
أما موضوع الانتصار والانكسار في حرب الحسين [ع] مع أعداء الله الذين حاربوا الله عن طريق أحد أبوابه. فاعلم: إن مقاييس الانتصار لدى أغلب البشرية هي مقاييس خاطئة بكل معانيها، فأكثر الحروب قائمة على أساس مادي، فإما للحصول على الأرض أو الأموال، أو السيطرة، لو سألت كل عاقل وجاهل عن أفضل المخلوقات؟ لقيل لك أنه الإنسان. وأن سألت عن اقل الموجودات شأناً؟ لقيل إنه التراب وهذا من الضروريات، إذن فكيف تضحي بأعلى المخلوقات من اجل الحصول على أدنى المخلوقات! وقد وقع ذلك كثيرا، فإذا فقدنا الإنسان وحصلنا على المال، فقد خسرنا الحرب. فإن من يأخذ منك أرضك خير من أن يأخذ روحك! فهل من خسارة أكبر من ذلك، فأين النصر؟؟ ولا أريد الاطالة، نعم لو كان ما تضحي من أجله أعظم من الإنسان فلا إشكال في ذلك، وليس ثمة شيء أعظم من الإنسان في عالم المادي، أما في عالم المعنى فموجود كالقيم السامية والاعتبارات العليا.
أما الحسين [ع] فلم يكن ينظر إلى النصر بالمعنى الظاهري ولم يكن ذلك بحسابه أبدا، إنما كانت له أهداف أراد تحقيقها من هذه المعركة، فإن حققها انتصر، وان لم تتحقق فشِل.
وكان تخطيطه من غريب التخطيط العسكري، وهو الانتصار في الانكسار والانكسار في الانتصار!!. فجعل الحسين أهدافه يحققها له أعداءه من حيث لا يشعرون! وذلك بإدخال هدفه لا مع أهداف أعداءه؛ بل في أهدافهم فحققوا له ذلك، فأخذ [ع] كل الفوائد من المعركة، وأخذ أعداءه كل الأضرار بالمعنى الواقعي الحقيقي.
ولو كُشف للعباد التخطيط الدقيق الذي وضعه الحسين [ع] لأجل الوصول إلى هذه النتيجة، لما تقبله العقلاء!.
فكل ما قدّم الحسين من تضحيات هي أقل من الثمرة بكثير الكثير. وبعدما حقق هدفه فلا يضره إن قيل خسر المعركة أو انتصر أو غيرهما، إنما كان ينظر إلى ما هو أعلى من ذلك، فقل ما شئت.
ومن جانب آخر، كـانت قضيـة الحسـين هي المرحلة الأساسية لقيام المرحلة الثالثة، واعني مرحلة الإمام الباقر [ع] فقد اعتمدت مرحلة الإمام الباقر اعتمـاداً كليـاً عـلى مرحلة الحسين، فبانت من ثمار قضية الحسين في عصر الإمام الباقر، أي في مرحلة تَحرُك العقل الإسلامي، وهذا هو الترابط التكاملي بين الأئمة (عليهم السلام).
ويقــابل مرحلــة عصــر الإمام [ع] ، العالم البـاطني للإمـام، فـإن لكل إمام عالَماً باطنياً تكاملياً يقابل العالم الظاهري. فكـان العـالَم البـاطني للحسين من أوسع العوالم الباطنية. وهذه العـوالم وجِـدت رحمـة مـن الحق تعالى تتحقق بها شفاعتهم فهي عوالم لأصحاب الاستعداد الضعيف، أي الـذي لا يسـتطيع المسـير المباشـر للحق، يدخل في عوالم الأئمة الباطنية، وان كانت ثمرتها اقل ولكـن هي مراحـل تطّـور ولها مستوى من الكمال لا يستهان به.
أما حقيقـة الحسـين [ع] فهـي من حقيقة الرسول بالتفصيل، أي أن الحسين ومحمد حقيقة واحدة، وكذا فاطمة والحسن حقيقـة واحدة، وعلي حقيقة واحدة، وكلهم حقيقة واحدة سلام الله وصلاته عليهم أجمعين، هذا عـلى مسـتوى من مستويات الحقيقة، فإن للحقيقة عدة مستويات في البواطن.
فمن أراد النظر إلى قضية الحسين فلينظر إلى كل جوانبها لا إلى جانب واحد.
(وله المنة أن جعل أولياءه معالم إرادته)



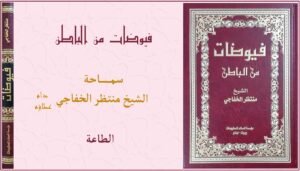
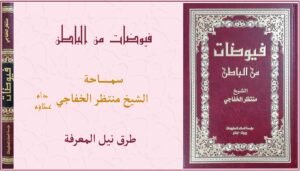
حفظكم الله تعالى مولاي الكريم